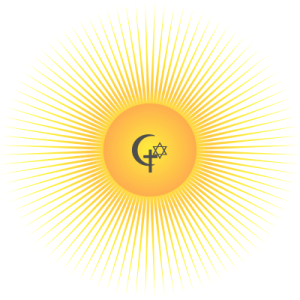جاء توجّه الناس قديمًا إلى الأديان والتعبّد ضمن مرحلة من التطور البشري، كنتيجة للشعور بالضعف والعجز، وشيوع الاعتقاد بالحاجة إلى الاستعانة بكائن قدير، لمواجهة المخاوف ولطلب الدعم المادي والمعنوي ولضبط سلوك الأفراد والجموع. كان الدين طريقة لإدارة الحياة وتحمّل الصعاب والصبر على المصائب، تضمّنت التحفيز والتقوية بمعتقدات إيجابية، والتنفير والتخويف من أفعال مكروهة. الطريقة نفعت البعض ونجحت نسبيًا بمقاييس زمانها؛ لكنها مرتبطة بالجهل والبدائية، قائمة على الدجل والخرافة، حيث أن الناس لم يكونوا قد تمكنوا بعد من تحقيق اختراق باتجاه الاكتشاف والمعرفة. وبعد زمن طويل، بتطور العلم والوعي، ابتكر الناس طرقًا جديدة لإدارة شؤونهم، تنحو بهم إلى القوة والتمكّن والثراء والتقدم المادي والفكري.
كان السياسيون ورجال الدين وما زالوا.. يستغلّون الدين لتطويعنا وتعبيدنا وتجنيدنا لتنفيذ رغبات ذوي النفوذ، كأحد أقوى السبل لتطبيق سياسة الترغيب والترهيب (العصا والجزرة)، بتنصيب إله عليّ عظيم يهابه الناس ويطمعون في كرمه، مثلما ترغّب الأم طفلها العنيد بلعبة أو حلوى وتُرهبه من وحش أو شخصية خيالية (البعبع، النمنم، أمنا الغولة، أم السعف والليف). المشكلة في الأديان وليست في من يستغلّونها. لم يتحرر أهل أوروبا من تسلّط السياسيين إلا بتحررهم من الدين؛ ولم يخضع العرب للسياسيين إلا بخضوعهم للدين. لم يكن ما فعله مؤسسو الإسلام سوى عمل سياسي توسعي.
ولذلك يتوجب أن نمنح الأولوية لانتقاد الأديان، لكي يرى الناس عيوبها، ويتخلّصوا منها وممن يستغلّونها.
وقد أثبت التاريخ مرارًا قابلية البشر للاستعباد بهذه الطريقة (خوفًا وطمعًا). وكمثال قريب على ذلك، نستذكر قصة جهيمان.. حيث انتشرت شائعات بوجود شخص تحققت فيها صفات الإمام المهدي المنتظر؛ فأدى هذا إلى تجنيد مليشيا قاموا باحتلال الحرم المكي معتقدين أنهم مجاهدون يمكّنون لإمامة المهدي، وبدأ الناس بمبايعته في الحرم. ثم انتهت العملية بقتل العديد من الأشخاص من بينهم المهدي المزعوم. هذا “المهدي” هو أنموذج مصغّر للأنبياء والرسل المزعومين، خاصةً الذين بسطوا نفوذهم بالسيف والعنف. الفرق الوحيد هو أن الثورة العلمية والصناعية في القرن العشرين مكّنت الدول الحديثة من مكافحة ودحر أولئك المجاهدين أو الجهاديين، جهيمان، القاعدة، داعش وغيرهم.
احتجّ الرافضون لاتّباع دين محمد بأنهم يتمسكون بدين الآباء؛ فرد مؤلفو القرآن بسؤال استنكاري:
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} 5|104
وقالوا أيضًا ردًا على خصومهم: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} 53|28
الآن نحن أحقّ منهم بإبداء هذا الاستنكار، فمعتقَد الإسلام هو ما وجدنا عليه آباءنا، وقد أضحت نوافذ العلم والمعرفة والفكر المتنوّر مفتوحة لنا، فأصبح لدينا أدلّة علمية وبراهين منطقية، بينما يتّبع المتديّنون الظنون المتوارثة. ليس اللوم على أهل القرون الماضية، فقد كانوا ضحايا الجهل؛ إنما اللوم على المتديّنين الجدد الذين يرون الأدلة والبراهين ويتجاهلونها أو يجحدونها، ويصرّون على الرجعية.
لا بد لنا من الاختيار بين الدين والعلم.. بين الإيمان بالغيب والخرافات، والوعي ومعرفة الحقائق. إن العاطفة غاشمة، والعقل عقالها. نحن وآباؤنا وأسلافنا استُعبدنا لكائن خرافي أمدًا طويلاً؛ ألم يأن لنا أن نتحرر من هذا الوهم؟
كما في القول المأثور، الأحمق.. هو من يريد أن ينفعك فيضرك. ليست المشكلة مع أتباع الأديان؛ إنما مع كلّ أحمق لديه نزعة للعنف أو إيذاء الآخرين أو التسلّط عليهم لكي يفرض معتقده وشريعته عليهم. إنه لو تأمّل بعمق في قرارة نفسه لوجد أنه لا يعلم هل ذلك ينفع أم يضرّ.
إن من نصّب نفسه حارسًا للدين.. لا يدافع عن الدين كما يزعم أو يتوهم؛ بل هو يدافع عن كيان قائم على نظام الامتلاك، قام مؤسسو الدين بتدعيمه وترسيخه تلبيةً لأطماعهم هم وأتباعهم. من يدافع ويهاجم حبًا في الامتلاك.. آمل أن يصحو ضميره.. أن يُشفى من ضمور الضمير، ويتخلى عن ذلك.
ربما بات كثير من الناس يعون أن دين آبائهم أُسّس على الخرافة والدجل، لكنهم يتجاهلون ذلك وينكرونه في العلن، خوفًا من الإرهاب والأذى والعقوبة ونبذ الأهل والأصدقاء. وحتى لو كتبوا بسم مستعار، قد يتمسكون بالدين حرصًا على أهليهم من الفوضى والانفلات، أو حفاظًا على منافع يمنحها الدين بنظام الامتلاك، وهُويةٍ مَجيدة (منتهية الصلاحية) بها عزة وكبرياء، وانتصارًا لذاتهم الفردية والجماعية ضد نقّاد دينهم، أو لكي لا يواجهوا الخوف الكامن ويتحملوا المسؤولية المصاحبة للحرية؛ (لذا عمّت الاتكالية على إله ودعاء “لا تكلنا إلى أنفسنا”؛) فالدين قد يتضمن حالة تسمى “روحانية”، وهي طمأنينة تريح النفس من القلق بهواجس الموت والفناء والظلم والشقاء.
كل هذا يدفعهم للدفاع عن الدين، حتى لو أيقنت نفوسهم أنه باطل، دفاعًا يصل إلى مقاضاة الخصم وإقامة حد الردة أو غيره من مسوغات إقصائه والتخلص منه، لأنه يهدد هذا الكيان المبني على باطل. هذا بالإضافة إلى القيام بتضليل الناس بالمنشورات والخطب الدينية المعدّة بانتقائية وحرص في تقديم النصوص المستحسنة الجذابة وحجب النصوص المستقبحة المنفّرة، ونشر أباطيل “الإعجاز”. لماذا كل هذا الحرص على نشر وترديد ما يؤيد الإيمان لدى الناس، وحجب كل ما يدعو للشك؟ لمصلحة من هذا المكر والتدليس؟
وحتى لو نظرنا في مجال القيم والأخلاق وانضباط سلوك الأفراد، في العموم، نجد انحطاط مستوى أتباع الأديان ذات الشريعة في هذا المجال بالمقارنة مع الشعوب المتحررة؛ وذلك لأن الشريعة حلت محل الضمير.
وما هذا التخلف والانحطاط إلا بسبب غياب حرية المعتقَد؛ فالبدائل الأفضل موجودة؛ ولا ينقصنا إلا نظام علماني يضمن حرية الاعتقاد والانتقاد والمساءلة للمعتقد السائد، ونشر الأفكار وأقوال الحكماء، والدعوة إلى البدائل ومناقشتها علنًا لبيان فوائدها وأضرارها واختيار أحسنها.
إن توريث المعتقدات خطيئة يمارسها البشر بحق أطفالهم. حرية المعتقد واختياره بلا وراثة ولا تلقين ولا إحراج أو إيذاء أو تهديد.. من أهم حقوق الإنسان.
لو كان هنالك إله يكافئ من يؤمن به ويعاقب الباقين، فليس من العدل أن يكون هذا الإيمان بالوراثة؛ العدل أن يهتدي إليه كل امرئ (أو لا يهتدي) بمفرده.
إن عدم معرفة كل الأجوبة خير من اتخاذ أجوبة خاطئة وهمية. الأساس في هذا الشأن هو أن ينال الإنسان حقه الطبيعي في حرية الاكتشاف والاختبار والمعرفة والاختيار.